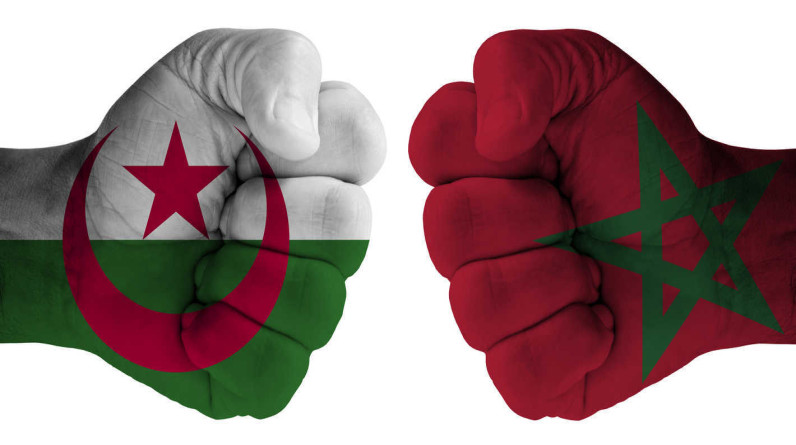-
℃ 11 تركيا
-
8 مايو 2024
جواد بولس يكتب: همسات محام: جليلي في القدس ومقدسي في الجليل
جواد بولس يكتب: همسات محام: جليلي في القدس ومقدسي في الجليل
-
8 سبتمبر 2023, 1:06:00 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كيف تغيّرت القدس إذا تغيّرت بنظرك؟ وهل تغيرت أوضاعنا عن أوضاعكم التي عشتموها حين جئتم شبابا إليها؟ هكذا سألتني ابنتي دانة قبل يومين، في السادس من سبتمبر، وإنا أتمم ليلتها السابعة والستين عاما من عمري، وأصبح، بمقتضى قوانين الدولة، «مواطنا مسنا». لم أكن فرحا تماما بحلول ذكرى يوم ميلادي، وهي في عرفنا الاجتماعي مناسبة للفرح، ولا حزينا تماما؛ بل كانت أفكاري مشوشة حد الفوضى، ومشاعري مضطربة. منذ أن بلغت الستين بدأت في مثل هذا اليوم أشعر كأن كسلا شديدا يستوطن رأسي؛ وكأن عقلي يدخل في حالة من الشلل المؤقت، ولا يدعني استعيد بعضا من حالي واستحضر فصولا من تعاريج حياتي الطويلة الماضية.
في الحقيقة، لم تكن رحلتي من كفرياسيف، مسقط رأسي الجليليّ الأنيق إلى القدس، عاصمة السماء، بسيطة وعادية. ولم أكن أتخيَل يوم اخترت الدراسة في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، أنني سأبقى في القدس، وأنني سأعمل فيها محاميا متخصصا في الدفاع عن أسرى الحرية الفلسطينيين، وعن كثير من المؤسسات الفلسطينية وعن قياداتها.
أضعنا القدس، وبقي العرب والمسلمون يحررونها في الصلوات ويسجنونها وراء أسوار الوهم بينما يعمل المحتل على ابتلاع جغرافيّتها وتحريف تاريخها وتفتيت هوية مجتمعها
حصل ما حصل وكأنه كان من تدابير القدر، أو ربما، هو حظي الذي سخّر لي الظروف قبل ثلاثة وأربعين عاما، وأتاحها كي أمضي في طريق كان مليئا بالتضاريس الصعبة، وبالمحطات التي عرفت على أرصفتها الشقاء والفرح والرضا. كنت شابا لا يعرف الكلل ولا يهاب عواء الذئاب، وكانت سجون الاحتلال تعرفني ويعرفني سكانها، المناضلون الفلسطينيون الذين ضحوا، وما زالوا يضحون، بالغالي في سبيل تحرير أرضهم وحرية شعبهم من نير الاحتلال. لم أنحز في عملي لفصيل فلسطيني على حساب فصيل آخر، فكل المضطهدين كانوا إخوتي، وكل السجناء، على اختلاف انتماءاتهم الوطنية والإسلامية، كانوا أمانات في عهدتي. لن يكفي مقال ولا حتى كتاب واحد للحديث عن تجربتي التي كنت فيها شاهدا على تداعيات وتقلبات كثيرة ولافتة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، بشقيه: نضالنا نحن الفلسطينيين الباقين في الوطن، ونضال أشقائنا الذين قرّبتهم منا نكسة يونيو عام 1967، وواجهوا مثلنا إسرائيل، التي من شهوة لا تشبع، ورصاص لا يرحم وفحم ودم، وخبروا، على أجسادهم، أنها ليست كما كان يصفها بعض العرب، مجرد فقاعة واهية وكيانا مزعوما ومؤقتا، وخللا في حسابات التاريخ سيسوّى قريبا.
أنهيت دراستي الجامعية وبدأت تدريبي في مكتب المحامية الشيوعية المناضلة فيليتسيا لانغر، وأُجزت محاميا، لأبدأ بعدها مسيرتي وأنا أعاني من حالة «انشطار نفسية»، إذ كنت، طيلة العقود الخمسة الماضية، أعتبر جليليّا في عيون معظم المقدسيين، وفي سائر أرجاء فلسطين، وأحيانا جليليّا مسيحيا في عيون بعضهم، ومقدسيا في عيون الجليليين، وبين عرب الداخل؛ أما مؤسسات وجنود الاحتلال فقد اعتبروني وزملائي المحامين «مخربين» نخدم «مخربين». إنها مفارقة أو ملابسة أنجبها لنا القدر، واضطررنا أن نعيش في كنفها باضطراب هويّاتي دائم، أنا وآلاف «النازحين» الفلسطينيين من عرب الداخل، منذ تركنا قرانا ومدننا في إسرائيل، واستوطنّا/ سكنّا القدس ومناطق فلسطينية أخرى، ساعين وراء أحلامنا أو رغبة منا بالتأكيد، ونحن الوافدين إلى أحضان أشقائنا الفلسطينيين، على هويتنا، أو من أجل تأمين أرزاقنا، بوجود فرص للعمل والتعلم والتقدم، رغم وجود الاحتلال، أو ربما بسبب احتياجاته. لم أنو اليوم منذ البداية الكتابة في الشأن الفلسطيني العام، ولا عن المناسبة الخاصة التي سألتني فيها ابنتي عن شعوري، ورغبت أن أستعرض، من أجل الإفادة، أمام الحاضرين بعض خلاصات تجربتي المهنية والإنسانية بعد أربعة عقود من العمل الحثيث في مواجهة الاحتلال ومؤسساته القضائية. كنا نجلس في القدس، في مطعم «سيتي ڤيو». وهو مطعم يتربع على أنف «جبل الزيتون» ويطل على البلدة القديمة التي كانت تبدو أمامنا كعروس نائمة وتحلم كما في الأساطير. كان الوقت مساء وفي الجو تهيم النسمات وتلفنا بحريرها المقدسي. استوعبت سؤال ابنتي ومرادها من ورائه وهممت بإجابتها، إلا أن أمها قاطعتني وهي تشير بيدها نحو القدس وتقول: هل هذه هي القدس التي عشقتك وعشقتها أنت؟ ثم أردفت بلهجة كسيرة وقالت: تذكّر وأنت اليوم تطوي 67 عاما، ماذا تبقى من القدس التي جئتها بعد هزيمة عام 1967 وكانت تلملم جراحها وتقاوم وترفض الاستسلام ويرفض أهلها التدجين أو الانصهار؟ حاولت ألا أكتب مرة أخرى عن القدس لأنني كنت قد كتبت عن جراحها بعد رحيل أميرها فيصل الحسيني مرات ومرات، فقلت لجلسائي إن الحديث عن القدس بالنسبة لي في مثل هذه المناسبة يشبه النبش في جرح ينزف في صدري قيحا ودما؛ فهي وإن كانت المبتدأ في كلام العرب، وكانت عند معظم المسلمين الخبر، بقيت الضحية الذبيحة وحرثا مباحا لسكك ولمعاول الغاصبين. المشكلة، يا بنيتي، أنني وكثيرين مثلي، أضعنا بعد أربعين عاما فلسطيننا وقدسنا وقضيتنا. أضعنا القدس، وبقي العرب والمسلمون يحررونها في الصلوات ويسجنونها وراء أسوار الوهم وتحت قباب مقدسة، فهم يهتفون لها من على منصات الوهم، بينما يعمل المحتل على ابتلاع جغرافيّتها وتحريف تاريخها وتفتيت هوية مجتمعها عن طريق إغراق حاراتها بالوعود وبالتساريح وبالتصاريح وبالفضة.
لقد جئت القدس بعد الهزيمة فوجدت أهلها صابرين يرفضون العيش في مذلة، ويصرون على المحافظة على هويتها الفلسطينية الواضحة التقاسيم والمعالم. ودافعت عن الأسرى وبينهم مناضلون مقدسيون كانوا لا ينامون إلا على عهد الكرامة والوفاء لأمهم فلسطين، والقسم بولائهم لها واعتبار كل سائر الانتماءات مجرد تفاصيل ثانوية وسطورا هامشية في صفحة الهوية الخلفية. فلسطين التي دافعت عن مناضليها لا تشبه فلسطين اليوم، والقدس التي عشقناها لا أجدها؛ وفي الوطن نسمع منذ سنوات أحاديث التيه وضياع الأفق واختلال معاني الثقة وفقدان الأمل. أتعبتني فلسطين العارية، والقدس عليلة تنام عميقا في الصدى بعد أن استبدلت فرسانها وهجرت سواقيها وأطاحت بنواطيرها، فلسطين التي تسألوني عنها تفتش اليوم عن بقايا روحها، والقدس تبحث عن ذراعها عساها تجد وريدها. أقول لكم هذا الكلام وفي قلبي غصة لأنني كابن لجيل خدم فلسطين في عصر كان إصرارها وعنادها ورفضها لكل ضيم، أعلاما ترفرف في زاوية ومنحنى، لن أنسى أنني تعلمت على أرضها معاني جديدة للفرح وللوجع وللنصر وللخيبة؛ وتعلمت منها كيف يكون الوفاء ولمن يجب أن تطلق الأناشيد ولمن تطيّـر الزغازيد، وخبرت في ميادينها كيف تصطاد «العصافير» وتسقط فوق قباب الحق، أو داخل أقبية الظلام. وفي فلسطين رأيت متى وكيف تخون نفوس الرجال أضلعها ويصير الواحد مسخ شيطان أو خنجرا من سم وطين مغروسا في خواصر الوطن. ما أجملها من رحلة فلسطينية وما أتعبها تجربة؛ حاولت خلالها أن أبقي كفرياسيف، قريتي الجليلية معشوقتي الأثيرة من دون أن تزاحم القدس، مقلة العين وعاصمة السماء، التي من أزقتها انطلقت، قبل تسرب اليأس إلى جدراننا، لمطاردة السراب في محاكم الاحتلال وفي سجونه. عشت بين كفرياسيف والقدس وعلى أكتافهما هرمت، وفي تلك المسافة، بين المرفأين، فتشت ووجدت معاني الحياة ونعمة الانتماء. على تلك الدروب صيغت هويتي وعليها تعبت وشاخت. ماذا تعلمت خلال عام منصرم وبعد بعض مسيرة؟ تعلمت أن هوية الشعب تكون مثل الشجرة فإذا لا يعتني بها أصحابها ولا يحافظون عليها تعبث فيها الرياح فتذبل وتهوي. وتعلمت أن الأمل هو مرجل الإرادة ومحرك النضال، فإن فقده الناس تشلّ عقولهم وتموت قلوبهم ويسكن الصمت في حناجرهم. وتعلمت أن شعبا لا يعرف للحب معاني ولا يمارس من أصنافه إلا حب ما يدخل الجيوب والأجساد ستكون مسيرته نحو الحرية والنور صعبة وعسيرة. وتعلمت أن شعبا يسعى للتحرر من نير قمع الاحتلال، ومن الاستعباد ولا يسكن الوفاء قلوب أبنائه، وأبناؤه لا يحترمون حقوق المختلف الآخر ولا قدسية الحياة، ستبقى حريته منقوصة ونضاله أعرج. لقد تعلمت في السنوات الأخيرة من صوت الرصاص المنفلت في مواقعنا إنه بالفعل قد تساوى بعد اختراع المسدس الجبان مع الشجاع. وتعلمت بعد شيوع مظاهر التفاهة وتكاثر التافهين، كيف مع اختراع الحواسيب وشبكاتها العنكبوتية تساوى الإنسان العالم مع التافه الجهول.
تحدثت عن القدس التي تربينا في حاراتها وشوارعها، وعن فلسطين التي كانت قضية كل واحد منا، وكنت أشعر بالحسرة وبالحنين. خبّرتهم كيف كنا مستعدين لبذل ما نقدر عليه في سبيلها، وكانت هي بالمقابل تجازينا بالكرم وبالحنان وبالأمان. كنت أحاول أن أتخيّل ماذا سأفعل بعد بلوغي الـ67، وأشعر بأن للقدس روحا كانت تسمعني وأنا أتحدث عنها من بعيد، وأنها مثلي تشعر بالوحدة وبالخذلان، لكنها ليست مثلي يائسة، لأنها، كما قلت هي عاصمة السماء ومقلة الوطن وقاف الحق الأبدية.
قبل يومين عبرت عتبة عام جديد، وأنا ما زلت ذلك الجليلي في القدس والمقدسي في الجليل؛ عبرتها وسأمضي كي أفتش عن خلي الوفي الذي سيحمي قلبي وظهري إذا ما غفوت ذات يوم سهوا في المكان الخطأ؛ ولأبحث عن الحكمة وراء القضبان عند من يربون الأمل رغم غدر السنين وعتمة الزنازين. سأكمل الطريق، إذ لا طريق آخر عندي، وسأصغي لحدسي فأهمل الساقطين وأرشف ما تبقى لي من رحيق في الدنيا مع الأحبة والأصدقاء.
كاتب فلسطيني
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات

 ثلاثاء, 07 مايو 2024
ثلاثاء, 07 مايو 2024 
 ثلاثاء, 07 مايو 2024
ثلاثاء, 07 مايو 2024 الأكثر قراءة

 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 جمعة, 28 مايو 2021
جمعة, 28 مايو 2021 حريات

 ثلاثاء, 07 مايو 2024
ثلاثاء, 07 مايو 2024 
 اثنين, 06 مايو 2024
اثنين, 06 مايو 2024 
 أحد, 05 مايو 2024
أحد, 05 مايو 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب